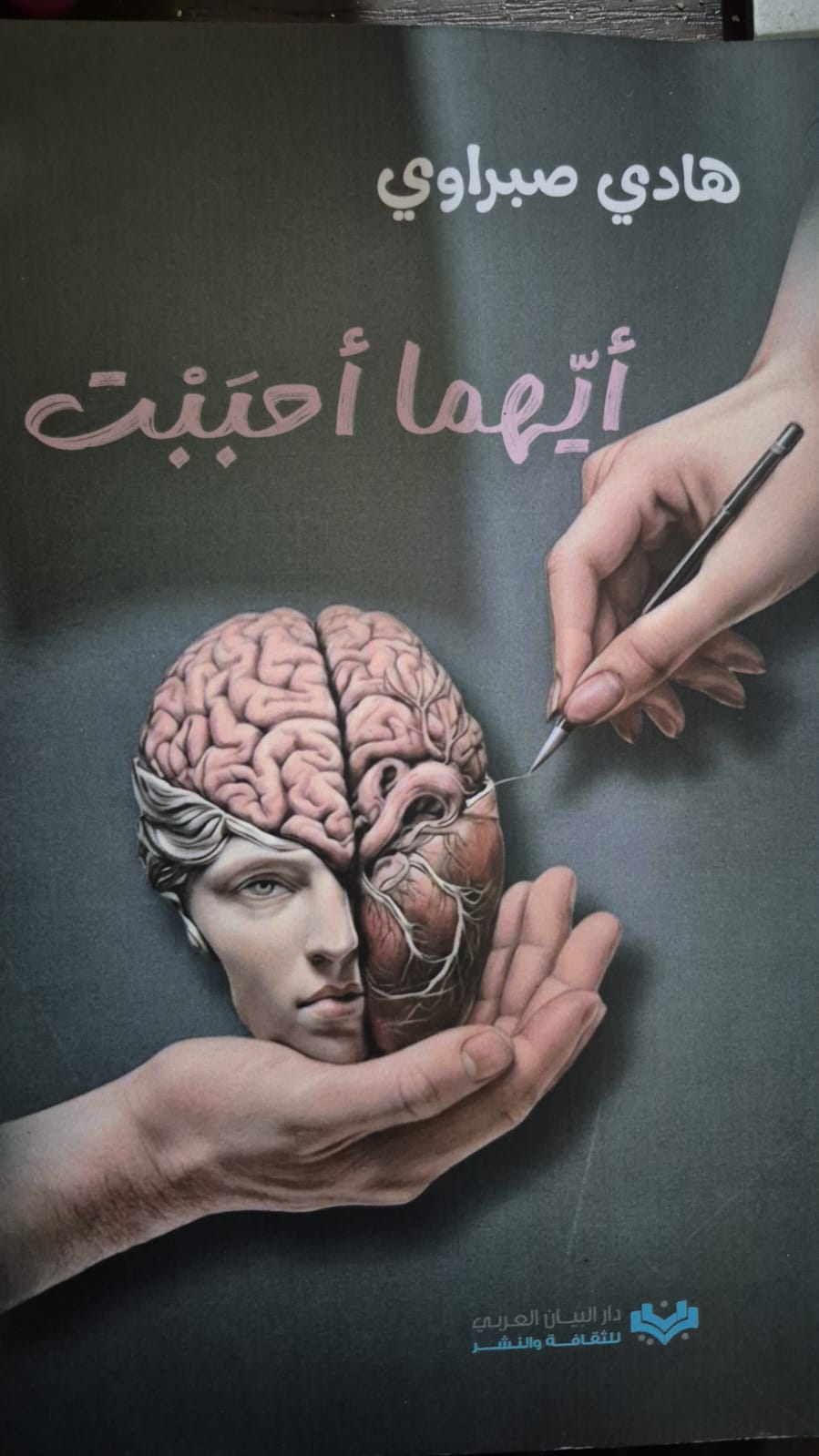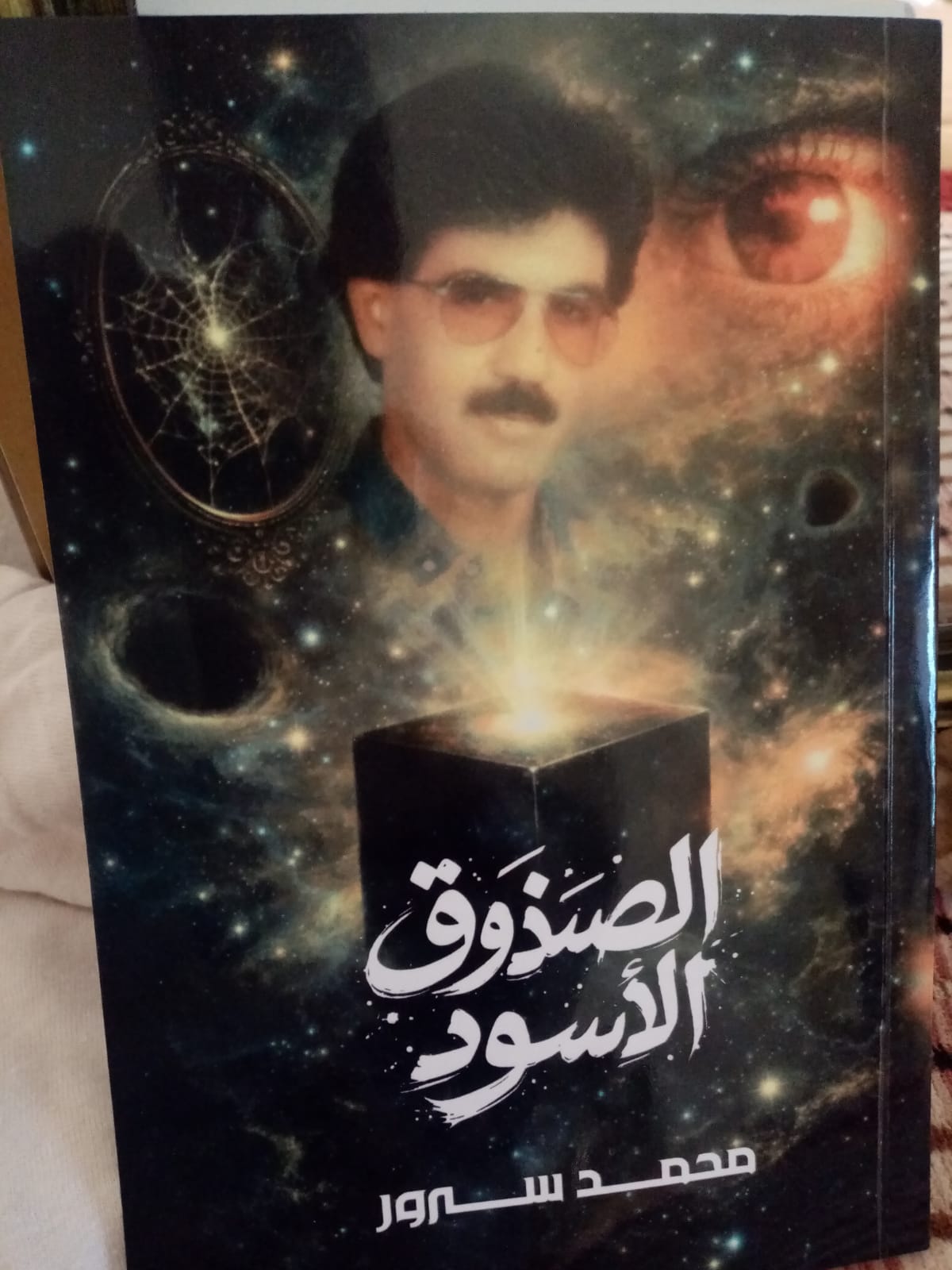الحزب بعد عام على الحرب : نحو مرحلة جديدة واستعداد لكل الاحتمالات
مرت في الايام القليلة الماضية الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية على لبنان والتي انطلقت في شهر ايلول من العام الماضي والتي ادت الى تعرض حزب الله والمقاومة الإسلامية لضربات قاسية بدات بعملية البيجر واللاسلكي واستهداف قوة الرضوان واستشهاد الامينين العامين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين والشيخ نبيل قاووق وعدد من الكوادر والقادة العسكريين وصولا لخوض الحزب معركة اولي الباس .
وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الى اين يتجه حزب الله في المرحلة القادمة وما هي الاستعدادات لمواجهة حرب اسرائيلية جديدة في حال قرر العدو الإسرائيلي العودة الى خيار الحرب الواسعة ؟
تقول مصادر مطلعة على اجواء الحزب : ان الحزب خلال العام الذي مضى ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي الكبير ال…
[2:42 م، 2025/10/1] A: كل الشكر
[7:46 ص، 2025/10/2] قاسم قصير: كتاب جديد من مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي
المفكر الإسلامي رضا برنجكار:
علوم الكلام والفلسفة والعرفان في ظلّ التشيّع
تقرير: سلوى فاضل
السؤال الأول الذي يطرح نفسه عند الاطلاع على كتاب ما هو: من هو المؤلف؟ وهل هو مختص بنصّه الذي يطرحه على القارىء؟ فما بالنا إذا كان الكتاب مختصًا بالعلوم الدينية ومترجم عن لغة ثانيّة لها إبحاراتها بالعرفان والكلام والفلسفة منذ القدم؟ ولماذا يترجم “ركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي” كتابا لمبتدئين أو كتبا تعليمية؟ كتاب تدريس يحكي البديهيات لطلاب العلم في الحلقات الأولى؟ وكيف جمع المؤلف 3 أنواع من العلوم كلّ نوع يقف مقابل الآخر ويُعتبر نقيضًا له؟
أجيب فأقول، بُعيد الاطلاع، إن الكتاب توثيقي يمكن للجميع الاستفادة منه، فهو كالقاموس العلميّ يحوي التعريفات والمبادئ والعناوين الرئيسة للأفكار المرتبطة بعلم الكلام والفلسفة والعرفان.
فمن هو رضا برنجكار الذي كتب هذا النص الموضوع في 208 صفحات، ونقله إلى العربيّة المُستعرب عباس جواد؟ مع عدد هائل من الإحالات والمصادر والمراجع التي تدل على أكاديميّة الباحث وتخصصيته؟
هو مفكر وباحث إيراني معاصر، مختص بالفلسفة وعلم الكلام، وله مؤلفات وأبحاث في مواضيع مختلفة مثل الفلسفة الإلهيّة، ونقد العرفان النظري، ونظرية المعرفة، وفلسفة الدين. منها: علم الكلام الإسلامي: دراسة في القواعد المنهجية، ودروس في العقائد والمعارف، والحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة، ودانش نامه عقاید اسلامی.
درَسَ الفقه والأصول والفلسفة والكلام الإسلامي في الحوزة العلميّة في قم، كما اهتم بالفلسفة الغربيّة. وهو حائز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة طهران. كما عمل في التدريس والبحث العلمي مع عدد من المؤسسات التعليميّة والبحثيّة في قم وغيرها. وهو عضو الهيئة العلميّة في جامعة طهران. كمانشر عددًا من الدراسات في المجلات والكتب.
في كتابه هذا يشرح أفكاره بثلاثة أقسام و12 فصلًا، تحت ثلاثة عناوين رئيسة (علم الكلام، والفلسفة، والعرفان). وقد خلص الدكتور رضا برنجكار إلى دراسة الفلسفة، والعرفان، مع تركيزه على علم الكلام. ويمكن تلخيص رؤيته على النحو التالي:
يولي علم الكلام أهمية خاصة، ويرى أنه ليس مجرد علم دفاعي أو جدلي يعتمد على مُسلّمات الخصوم، بل هو علم له متطلباته وأصوله للتطبيقات الخاصة التي يجب أن يكون واضحا وتوضيحه.
وعلى الرغم من أن برنجكار أعلن التداخل بين الفلسفة وعلم الكلام، وخاصة بعد الفترة التي تلت صراع الغزالي وابن رشد، إلا أن منهجه يتجه نحو تأصيل الكلام كعلم قائم بذاته. فقد توّصل إلى أنه هناك تقدير كبير لأهمية التنفيذ، الذي أسسه فلاسفة مثل صدر المتألهين في الحكمة المتعاليّة، والذي يجمع بين الفلسفة البرهانيّة والعرفان الذوقيّ في النظام المعرفيّ الواحد. ويمكن القول إن برنجكار مُنظِّرًا معاصرًا رياضيًا دعا إلى إعادة الاعتبار لعلم الكلام كعلم أصيل، فوضعه ضمن إطار دراسة شاملة خاصّة بالفلسفة والعرفان.
نقاش شامل
شكلت النظريات الإسلامية إرثاً حضارياً ضخماً وعميقاً، شملت دراسات عقليّة، وفلسفيّة، وروحانيّة. من بين أهم هذه الفروع التي تتولى التوسط بين النص المقدس والعقل، تبرز ثلاثة محاور رئيسة: علم الكلام، والعرفان، والفلسفة الإنسانيّة. وقد أثرت هذه العلوم وتأثرت بالحضارات السابقة، وأسهمت في تشكيل الفكر العالمي.
علم الكلام أو اللاهوت
علم الكلام هو العلم الذي يدرس العقيدة الدينية، ويثبتها بالأدلة المستقلة، ويدفع الشبهات عنها. وُلد هذا العلم في خضم الفتن السياسيّة والاجتماعية الذي تلت عصر النبي محمد(ص)، وأظهر الحاجة إلى تشكيل موقف عقديّ مُتجانس ومبرهَن يواجه التحديات.
الجوهر والهدف
لأن علم الكلام لاهوت يتصدّى للأسئلة الجوهريّة الصعبة المتعلقة بذات الله وصفاته كالتوحيد، والعدل الإلهي، والقضاء والقدر، والبعث والحساب، فهدفه الأساس هو الوصول إلى الإيمان، وحفظ العقيدة من التشكيك والانحراف.
المدارس الرئيسة
المعتزلة: أصبحت مدرسة العدل والتوحيد. تم التشديد من خلالها على الاهتمام بالنصوص في فهم النصوص، وأثبتت حرية الإرادة كالاختيار، ومفهوم العدالة الإلهيّة، حيث نفت الامتيازات عن حرية الاختيار في التجسيم الإلهي. ومن أبرز رموزها: واصل بن عطّاء، والجاحظ.
الأشاعرة: مدرسة تأسست على يد أبي الحسن الأشعري، وهي تمثل رد فعل على إفراط المعتزلة في استخدام العقل، والالتزام بين الإصلاح والعقل، على أن صفات الله قائمة بذاته، وأثبتت القدرة المُطلقة لله على خلق أعمال العباد كالكسب عند الأشعري، مما يُقلّل من حرية الإرادة البشرية.
الماتريدية: تُنسب إلى أبي منصور الماتريدي، وتنتشر بشكل خاص في منطقة آسيا الوسطى. وتتفق مع الأشاعرة في الكثير من الأصول، وتختلف في بعض التفاصيل، مثل إعطاء دور أكبر للعقل في إدراك حسن وقبح التصرف قبل الوصول إلى الشرع.
مدرسة الإشراق: أسسها شهاب الدين السهروردي. دعت لدمج الحكمة الفارسية القديمة وبعض الأفكار الأفلاطونية مع التصوف، وترى أن المعرفة اكتملت بالإشراق (الحدس أو النور الباطني) بالإضافة إلى المنطق.
المدرسة المشائيّة: تُمثل الكتاب الأرسطي في الفلسفة الإسلاميّة. أبرز روادها: الكندي ويُلقب بفيلسوف العرب. كان له دور رائد في نقل وترتيب الفلسفة اليونانية. والفارابي: ويلقب بـ”المعلم الثاني” بعد أرسطو. صاغ نظرية المدينة الفاضلة، وطوّر نظرية الفيض، وأسس مذهبًا يربط بين الأفلاطونيّة والأرسطيّة. وابن سينا: أعظم فلاسفة الإسلام وأطبائه. جمع بين سبب وجود الله ووجود الوجود. وابن رشد: له مُعلقة كبرى على أرسطو. دافع عن الفلسفة في وجه المتكلمين مثل الغزالي في كتابه “تهافت الفلاسفة”، والمعرفة عنده هي عدم تعارض الحقيقة البشرية مع الحقيقة التي جاء بها الشرع.
التدوين: شكّل علم الكلام العمود الأبرز لتدوين العقائد في الإسلام، وأدى إلى تفعيل حقوق الطبع والنشر والنظرية في فهم أصول الدين.
العرفان: هو الوجه الروحي والذوقي للإسلام. هو في جوهره منهج عملي يقوم على تطهير النفس والزهد والرياضات الروحيّة أي التصوف العملي، لكنه أثبت أنه نظام معرفي.
الجوهر والهدف: بينما يعتمد الفيلسوف على العقل والمنطق، والمتكلم على الجدل والاستدلال، والرياضي العارف إلى المعرفة والمكاشفة كالذوق وحق ذوق الوجود، يرى العارفون أن الأحداث الكبرى لا يمكن أن تدرك بالحدود أو بالاستدلال، بل بالاتصال الروحي.
الوحدة الشهودية/الوجودية: من أهم أفكار العرفان، خصوصًا بعد محيي الدين ابن عربي.
وحدة الوجود: مفهوم يشير إلى أن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده، وأن العالم وما فيه ما هو إلا الوجود وتجليات هذا الوجود الواحد. هذا المفهوم المبتكر واسع النطاق في التاريخ الإسلامي.
الإنسان الكامل: هو النموذج المثالي الذي يجسد الأسماء والصفات الإلهيّة بشكل تام في العالم. ويرى ابن عربي أن هذا الإنسان هو النبي محمد(ص) والأنبياء والأولياء من بعده.
الفيض والإشراق: مفهوم يشرح كيفية صدور العالم عن الله، فالوجود يفيض من مصدره الأحد، والنور والمعرفة تُشرق على قلب العارف المستنير.
الفلسفة الإسلامية
الفلسفة الإسلاميّة هي الفلسفة التي انتشرت وازدهرت في ظلّ الحضارة الإسلامية، وتمكّن الفلاسفة المسلمون في محاولة توفيقية بين التراث اليوناني (أفلاطون وأرسطو بشكل خاص) والعقيدة الإسلاميّة.
الجوهر والهدف
هدف الفلسفة الإسلاميّة الأساس هو البحث عن الحقيقة الكليّة بواسطة البرهان. واجه الفلاسفة تحدّيا في كيفية استيعاب مفاهيم مثل قِدَم العالم، وصدور الكثير عن واحد، ضمن إطار عقيدة التوحيد الإسلاميّة التي تؤكد على خلق العالم من عدم.
الصراع الفكري
تضمنت الفلسفة الإسلامية تفسيرًا فكريًا هامًا مع علم الكلام، خصوصًا بعد كتاب الغزالي “تهافت الفلاسفة”، الذي نقد فيه الفلاسفة في قضايا مثل قِدَم العالم، وعلم الله بالجزئيات، والبعث الجسدي. وقد ردّ عليه ابن رشد بـ”تهافت التهافت”. هذا الجدال يدل على الفكر الإسلامي وعمقه.
نظرية برنجكار الكلاميّة
يُعد الدكتور رضا برنجكار من الشخصيات الأكاديمية المعاصرة في إيران التي كرست جهودها لأبحاث علم الكلام والفلسفة الإسلاميّة. بما أن أي باحث في هذا المجال ينتمى إلى المدرسة الحديثة الناشئة، وما زال بالحكمة المتعالية الذي أسسها صدر المتألهين، بمنهجه المشهور الذي يجمع بين البراهين المستقلة (الفلسفة)، والنصوص المعاصرة (الكلام)، والكشف الروحي (العرفان). لكن يظهر من تركيز برنجكار اتجاهًا واضحًا نحو إعادة التأهيل وإثبات استقلالية علم الكلام كمنهج بحثي مستقل، وليس مجرد إضافة للفلسفة أو فرع ثانوي.
وينطلق برنجكار من فرضية أن علم الكلام، على الرغم من تعرّضه لانتقادات شديدة، خصوصًا من الفلاسفة الذين وصفوه بأنه “علم جدلي” يعتمد على مقدمات مشهورة لا يقينيّة، هو في حقيقة علمه يستهدف البرهان في أصول العقائد.
ويرى برنجكار أن القول بأن علم الكلام جدلي مطلق هو تبسيط وتعميم غير دقيقين. ونتيجة لذلك، فإن العديد من المتكلمين، خاصة في العصور المتأخرة، تبنّوا العديد من البراهين المؤكدة للمنطق الأرسطي للفلاسفة (كالوجوب والمكان). فالهدف يُعد مجرد خصم للخصم، بل يتوصل إلى اليقين في الفكرة الجوهرية. استطاع برنجكار أن يوّفق بين الكلام والفلسفة فوصل إلى درجة من التداخل.
الفلسفة كأداة لا كهدف
في المرحلة المُتأخرة من علم الكلام، دخلت الفلسفة عنصراً أساسياً في بناء الأدلة الكلاميّة. ويقر برنجكار تلك الفلسفة المُقدمة بأدوات منطقيّة ومفاهيم وجودية مثل الوجوب والمكان، والجوهر والعرض التي ساعدت المتكلمين على الاحتجاج لمنعهم من الحصول على قدر أكبر من التفاصيل والدقة. لكن الفلسفة هنا هي أداة برهانية لخدمة العقيدة، وليس كمصدر مستقل.
وتوصل برنجكار إلى بيئة فكرية تقدّر العرفان النظري أي التصوف الفلسفي، وخاصة ما صاغه محيي الدين ابن عربي وصدر المتألهين. وهذا التنوع لآلهة بعض الحكماء.
في نهاية المطاف، يمكن أن ينظر إلى رأي برنجكار في العلوم الإسلاميّة الثلاثة يتجهون إلى رؤية تكامليّة للمشاركة بـمدرسة الحكمة المتعالية، والتي تركز على أهمية علم الكلام، واستخدام الفلسفة كأداة، وتمام المعرفة كغاية.
ويركز برنجكار على الجانب التنظيمي والمنهجي لهذه العلوم وبقائها أدوات قوية للفهم والتفسير في مواجهة التحديات المعاصرة.