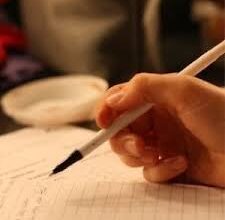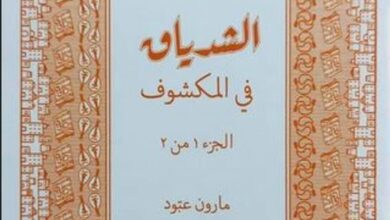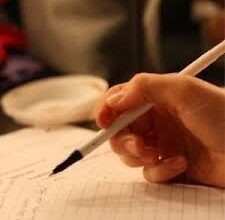من كلماتِ الإمامِ الحسنِ (ع) ومواعظِهِ في ذكرى وفاتِه بقلم العلامة السيد علي فضل الله
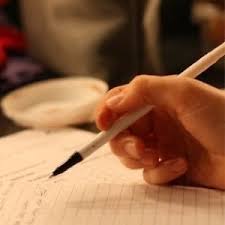
قال الله سبحانه: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}(آل عمران: 175). صدق الله العظيم.
في السَّابع من شهر صفر، سنكون مع ذكرى حزينة على قلوب الموالين لأهل البيت (ع) ومحبّيهم، وهي ذكرى وفاة الإمام الثَّاني من أئمّة أهل البيت (ع)، وهو الإمام الحسن بن عليّ (ع)، هذا الإمام هو من أولئك الَّذين نزلت فيهم الآية التي تلوناها، وممن أمر الله رسوله (ص) بمودَّتهم، فقال: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}، ومن قال فيهم: “إنِّي تارك فيكم الثَّقلين، ما إن تمسَّكتم بهما لن تضلّوا بعدي؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي”.
تربيةٌ رساليَّة
وقد حظي هذا الإمام بتربية أمِّه الزَّهراء (ع) وأبيه عليّ (ع)، وبرعاية خاصَّة من جدِّه رسول الله (ص)، فهو من سمَّاه باسمه الَّذي لم يسمَّ به أحد من قبله، وكان (ص) يعبِّر عن حبِّه له، ويتوجَّه إلى الله بالدّعاء إليه: “اللَّهمَّ إنِّي أحبُّه فأحبَّه”. وانطبعت به (ع) شخصيَّة رسول الله (ص) خَلقاً وخُلقاً، وهذا ما أشار إليه رسول الله (ص) بقوله: “أشبهْتَ خَلْقي وَخُلُقي”، فقد كان النَّاس إذا اشتاقوا إلى رسول الله (ص)، يتطلَّعون إلى الحسن (ع)، وكانوا يجدون عنده علمه وحلمه وعبادته وزهده وتواضعه وعطاءه وكرمه.
وبعد وفاة رسول الله (ص)، شارك الإمام الحسن (ع) أباه أمير المؤمنين (ع) في حمل أعباء الخلافة، فكان عضداً له، وذراعه اليمنى في المهمَّات الصَّعبة، وإلى جانبه في ساحات القتال، في الجمل وصفِّين والنّهروان، والتي أبدى فيها شجاعةً وبأساً، حتى إنَّ أمير المؤمنين (ع) كان يخشى عليه من شدَّة بأسه، وقد ورد أنَّه لما رآه في معركة صفّين يخوض وسط الأعداء، قال لأصحابه: “املكوا عنِّي هذا الغلامَ لا يهدّني، فإنَّني أنفس بهذين – يعنى الحسن والحسين (ع) – على الموت، لئلَّا ينقطع بهما نسل رسول الله (ص)”.
التَّحدِّياتُ الصَّعبة
وقد تولى الإمام الحسن (ع) الخلافة بعد استشهاد أبيه أمير المؤمنين (ع)، في مرحلة هي من أصعب المراحل وأشدِّها حراجة، ولعلّ التحدّي الأبرز الَّذي واجهه من معاوية، هو عندما رفض البيعة للإمام (ع)، ولم يكتف بذلك، بل قاد جيشاً لمنعه من تسلّم مقاليدها، ما دفع الإمام (ع) يومها إلى استنفار أصحابه لردّ هذا العدوان، وأعدَّ لذلك جيشاً قدِّر بأربعين ألف فارس، لكنَّ الإمام (ع) عاد وفضَّل الدخول في الصلح، ورآه الخيار الصَّحيح والواقعيّ في تلك المرحلة، بعدما استطاع معاوية أن يستميل الكثيرين من جيش الإمام (ع) وأغراهم بالمال، وبعد أن رأى لا فائدة ستحصل لو أنَّه دخل في معركة ستكون خاسرةً على الصعيد العسكري، وستؤدِّي إلى التضحية بالخلّص من أصحابه، ذلك أنّه في تلك المرحلة، لم يكن الكثير يعرفون حقيقة معاوية ومشروعه التَّدميري للإسلام، حيث كانت فئة كبيرة من المسلمين تعدّه صحابياً ومن كتّاب الوحي.
فأراد الإمام (ع) من خلال الصّلح أن يعيد تنظيم جيشه، ويتخلَّص من الوهن الذي أصابه، وأن يعطي فرصة للنَّاس ليروا حقيقة ما عليه معاوية. وفعلاً، أظهرت الأحداث اللاحقة صحَّة ما سعى إليه الإمام الحسن، عندما رأوا معاوية يستبيح دماء الموالين لآل بيت رسول الله (ص) وصحابته، ويتنكَّر لعهد الصّلح، ويقول مباشرة بعد التَّوقيع له: “كلّ شيء أعطيته الحسن بن عليّ تحت قدميَّ هاتين، لا أفي بشيء منه”. وعندما عيَّن بعدها ولده يزيد، الرّجل الفاسق الفاجر القاتل للنَّفس المحترمة، ليكون خليفة من بعده، رغم أن من بنود الصّلح أن يتولى الخلافة من بعده الإمام الحسن (ع)، وإن حدث شيء له فللحسين (ع).
واستكمل ذلك بدس السّمِّ للإمام الحسن (ع) عبر زوجته الَّتي أغراها لتقوم بهذا الفعل، ليخلو الجوّ لولده يزيد، ما هيَّأ الظّروف بعد ذلك لثورة الإمام الحسين (ع)، ولتحقيق النتائج التي أدَّت إليها.
ونحن في أجواء هذه المناسبة الأليمة، نستحضر اليسير من كلماته ومواعظه الَّتي كان يبثها بين أصحابه، لنستعين بها في حياتنا.
من كلماتِهِ (ع) ومواعظِهِ
الحديث الأوَّل الَّذي أشار به إلى سبب هلاك الأفراد والمجتمعات، فقال (ع): “هلاك المرء في ثلاث: الكبر – ويعني أن يعجب الإنسان بنفسه ويراها أعلى من غيره، لأنَّه يمتلك مالاً أو موقعاً أو علماً أو عشيرة، من دون أن يعي ما لدى الآخرين من قدرات وإمكانات ومميزات – والحرص – ويعني الجشع في أمور الدنيا، وعدم الاكتفاء بما عنده، رغم أنَّه يسد حاجته – والحسد – وهو أن يتمنَّى السوء للآخرين لأنَّهم يملكون ما لا يملك.
– فالكبر – كما أشار الإمام الحسن (ع) – هلاك الدِّين، وبه لعن إبليس – وأدَّى إلى طرده من الجنَّة، وفي ذلك قول أمير المؤمنين (ع): “اعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس، إذ أحبط عمله الطَّويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله ستَّة آلاف سنة، لا يدرى أمن سني الدّنيا أم من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة”.
– والحرص عدوّ النَّفس، وبه خرج آدم من الجنَّة – عندما أكلا من الشَّجرة التي نهاهما الله عزَّ وجلَّ عنها – والحسد رائد السّوء، ومنه قتل قابيل هابيل”.
الحديث الثَّاني، والَّذي أراد الإشارة إلى صفات من يستحقّ أن ينعت بالشّيعي، حين ردَّ على ذلك الرَّجل الَّذي قال عن نفسه: أنا من شيعتكم والموالين لكم، بقوله: “يا عبد الله، إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعاً فقد صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك، فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها، لا تقل: أنا من شيعتكم، ولكن قل: أنا من مواليكم، ومحبّيكم، ومعادي أعدائكم. وأنت في خير، وإلى خير”. فالتشيّع ليس انتماءً عاطفيّاً فحسب، بل هو التزام بما جاء به أهل البيت (ع) ونهوا عنه، وتعبير عمَّا جاء عن رسول الله (ص).
الحديث الثَّالث: أشار فيه إلى تعريفه للسياسة، فقال السياسة: “أن تراعي حقوق الله، وحقوق الأحياء، وحقوق الأموات. فأمَّا حقوق الله، فأداء ما طلب، والاجتناب عمَّا نهى. وأمَّا حقوق الإحياء، فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك، ولا تتأخَّر عن خدمة أمَّتك، وأن تخلص لوليّ الأمر ما أخلص لأمَّته، وأن ترفع عقيرتك في وجهه إذا حاد عن الطَّريق السويّ. وأمَّا حقوق الأموات، فهي أن تذكر خيراتهم، وتتغاضى عن مساوئهم، فإنَّ لهم ربَّاً يحاسبهم”.
الحديث الرابع: حصل عندما سأله رجل أن يجالسه، فقال له: “إيَّاك أن تمدحني، فأنا أعلم بنفسي منك، أو تكذِّبني، فإنَّه لا رأي لمكذوب، أو تغتاب عندي أحداً”. فقال له الرَّجل: ائذن لي في الانصراف.
الاهتداءُ بسيرتِهِ (ع)
أيُّها الأحبَّة: إنَّنا أحوج ما نكون، ونحن نستعيد ذكرى ارتحال هذا الإمام إلى ربِّه سيِّداً في الجنَّة، بأن لا نكتفي بتعابير الحزن وإقامة مجالس العزاء عليه، وهو من يستحقّها، لجهاده وتضحياته ومعاناته وابتلاءاته، بل أن نعمل، كما هو دعا، بهدي سيرته، وأن نستهدي بكلماته التي تضيء لنا طريق حياتنا، وتجعلنا أكثر وعياً ومسؤوليّة، وأن ندعو إليها، وبهذا نخلص لهذا الإمام، ونكون أوفياء له، ونحيي أمره، ونكون ممن يستحقّون أن ينالوا شفاعته يوم نلقى الله عزَّ وجلَّ.
جعلنا الله عزَّ وجلَّ منهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين